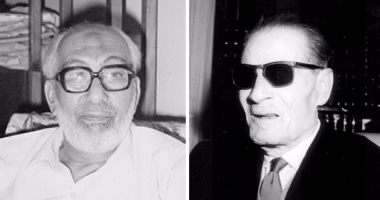ما لنا كلÙّنا جَـو٠يـا رسولÙ
أنا أهوى، وقلبكَ المتبول٠!
أبو الطيب المتنبي
أ – مدخل:
بقدر من التأمل ÙÙŠ Øياة الأعلام والكتّاب، وبشيء من التدقيق Ùيما كتبوه قد نتمكن من الوصول لعدد من بواعث توجههم الÙكري واهتماماتهم المعرÙية، ومن أبرز الوسائل الـمÙعينة على هذا: تتبÙّع الأساتذة الذين تتلمذ العالÙÙ… أو الكاتب على أيديهم، أو اختار المضيّ على دروبهم المعرÙية، ستسمع مثلاً أبا عمرو بن العلاء ÙŠÙوسوس لك وسط Ø£Øاديث الأصمعي وآرائه النقدية، ÙˆØ³ØªØµØ§Ø¯Ù Ø±ÙˆØ Ø£Ø¨ÙŠ إسØاق النظّام وعقليته المتسائلة ÙÙŠ كثير من وقÙات الجاØظ المباغتة لك، وقد تتعر٠على نبرة المعري الميّالة لمخالÙØ© المألو٠وأنت تتصÙØ Ø¢Ø±Ø§Ø¡ تلميذه: ابن سنان الخÙاجي الجريئة، كتأييده مثلاً للقول بالصرÙØ© ÙÙŠ إعجاز القرآن.
ÙÙŠ المقابل هناك بعض المؤلÙين والكÙتّاب لن تجد Ù…Øرضه الأكبر على الكتابة متمثّلاً ÙÙŠ أساتذته الذين ارتضى نهجهم، واقتÙÙ‰ أثرهم، بل ÙÙŠ كاتب٠سابق له ومخال٠له ÙÙŠ التوجه الÙكري اصطدم بأطروØاته -ربما دون قصد مسبق- Ùرجّته رجّاً جعله يعيد النظر ÙÙŠ كل ما تلقّى وقرأ، ولكن Ø±ÙˆØ Ø§Ù„ØªØدي والمقاومة داخله دÙعته إلى أن يشقّ طريقه الخاص والمتجاÙÙŠØŒ لكي يسجّل أمام Ù†Ùسه أولاً، ثم أمام عصره ومÙجايليه ثانياً قدرته على اتخاذ موق٠مستقل وضدي من هذه الأطروØات الصادمة له، وربما أمضى عمره كله وهو ÙŠØاول إقناع Ù†Ùسه بصواب توجّهه الناقض لتلك الأطروØØ©ØŒ وغالباً ما نرى هذا التوجه الجذري ÙÙŠ ضدّيته، والذي يكاد يختصر Øياة بأكملها لدى الكّتّاب الأكثر Øساسيةً ÙÙŠ استقبال الأÙكار، والتيقّظ للوازمها، ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªØ´Ø±Ø§Ù Ø§Ù„Ù„Ù…Ù‘Ø§Ø Ù„Ù…Ø¢Ù„Ø§ØªÙ‡Ø§.
هذا يعني أننا نتØدث عن ØªÙ„Ø§Ù‚Ø Ø®Ù„Ø§Ù‚ بين الأضداد -أو بين ما يبدو للعيان أنهم أضداد- وهنا ÙŠØتاج الأمر إلى ØÙر أعمق لاكتشا٠هذا Ø§Ù„ØªÙ„Ø§Ù‚Ø Ø§Ù„Ø®Ùيّ الذي يظهر أمام الناس بصورة: هجوم ساÙر، أو صÙدام عنيÙØŒ أو اعتراض مشاكس، أو تØÙّظ ØØ°Ùر، أو تجاهل Ù…ÙكابÙر، أو سخرية Ù…ÙستخÙÙّة.
هكذا ستجد مثلاً القاضي عبدالجبار ثاوياً ÙÙŠ عقل عبدالقاهر الجرجاني الذي جعل همّه أن ينقض آراء هذا العالÙÙ… المعتزلي الكبير، مجيّراً Ùكرة النظْم ذات الجذور الاعتزالية/الجاØظية، لتغدو Ùكرة أشعرية تنتصر لأطروØØ© (الكلام النÙسي).
وسترى ابن سينا يمتØÙ† بـ(Ø´Ùائه) طمأنينة الغزالي، ويÙدخله سرداب الØيرة، وينازعه Ù†Ùسه التي بين جنبيه، ÙيندÙع أبو Øامد ليÙØامي عن ذاته المØاصرة وعالمه المهدّد وسكينته المÙقودة بتصني٠(تهاÙت الÙلاسÙØ©)ØŒ مقرّراً ضلالهم وكÙرهم ÙÙŠ ثلاث مسائل ÙƒÙبرى -وابن سينا على رأسهم- Ùيما كان الغزالي ÙÙŠ الوقت Ù†Ùسه يواجه -ÙˆØيداً- “ثورة الشك†العاصÙØ© والمتوارية وراء ثباته الظاهر، ÙˆÙŠØ³Ø¨Ø Ø¬Ø§Ù‡Ø¯Ø§Ù‹ ضد التيار الÙلسÙÙŠ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ رماه ابن سينا بين أمواجه، ليجد أخيراً مرÙأه (المنقÙØ° من الضلال) يتخايل أمامه على مشار٠جزيرة التصوÙ.
بعد قرن تقريباً ستصاد٠الغزالي مرةً أخرى يومئ إليك بالتØية وسط مؤلÙات الÙيلسو٠ابن رشد التي كان ينقض Ùيها آراء أبي Øامد، مقرّراً (تهاÙت التهاÙت)ØŒ ومشنّعاً ÙÙŠ (Ùصل المقال) عليه وعلى سائر المتكلمين هذا الاضطرابَ الواسع الذي Ø£Øدثوه ÙÙŠ عقول العوام، نتيجة توسعهم ÙÙŠ التأويل المجازي للشريعة، بينما كان ابن رشد ÙÙŠ الوقت Ù†Ùسه يعتمد ÙÙŠ Ù…ÙراÙعته التي داÙع بها عن الÙلسÙØ© على ثنائية الغزالي المÙضّلة التي يميز Ùيها بين: ظاهر العوام، وباطن الخواص.
ÙˆÙÙŠ زمننا المعاصر سترى Ù…Øمد عابد الجابري ÙŠÙطل عليك خل٠نظارات جورج طرابيشي التي أراد أن يتÙØّص بها أخطاء الجابري وسقطاته ÙÙŠ (نقد العقل العربي)ØŒ Ùإذا هو يكتش٠قبيل ÙˆÙاته أن كل ما كتبه من مؤلÙات متعاقبة ضد مشروع الجابري لم يكن سوى إقرار ضمني بأثره الهائل ÙÙŠ تكوينه الÙكري، ÙˆÙÙŠ انعطاÙÙ‡ الاستكشاÙÙŠ الأخير Ù†ØÙˆ التراث.
سيطلع لك الجابري أيضاً ومجدداً من وراء عباءة طه عبدالرØمن الضاÙية، وسترى أن هذا المشروع الطاهوي الضخم، Ø§Ù„Ø·Ø§Ù…Ø Ù„ØªØ£Ø«ÙŠÙ„ الأÙكار والمÙاهيم ضمن السياق التداولي العربي لم يكن ليتØقق لولا المساÙØ© التي أراد طه عبدالرØمن أن يقطعها انطلاقاً -واÙتراقاً- من عتبة (المÙكّر Ùيه) عند غريمه الجابري.
وبعيداً هناك: ربما يتسنى لك أخيراً أن تتأمل الموسيقار الألماني ريتشارد Ùاغنر وهو يعز٠مقطوعته المÙضلة على مسمع من نيتشه الذي ÙŠÙØ´ÙŠØ Ø¨Ù†Ø¸Ø±Ù‡ المتعالي بعيداً ÙˆÙÙŠ صدود ظاهري، بينما تهتز خلجاته لكل نقرة ÙÙŠ الإيقاع الآسر.
ب-النموذج:
من بين هذه المواق٠الـمÙجاÙية التي تصنع من التجاÙÙŠ Øياة كاملة: موق٠مØمود شاكر من أطروØات طه Øسين، ويمكن أن نقول ابتداءً: إنك لن تÙهم إنتاج Ù…Øمود شاكر، وتستوعب بواعث صاØبه وغاياته منه، ما لم تقرأ المØرّض الأكبر له: طه Øسين.
ÙÙŠ الواقع Ùإن المشروع العلمي لمØمود شاكر يكاد يكون -وبإقراره المتناثر والمتواتر ÙÙŠ كتبه- تÙنيداً طويل الذيول وممتد الØواشي لأÙكار طه Øسين وأطروØاته المÙارقة.
1-الصدمة:
لطالما تØدث شاكر عن (الزلزال) الذي Ø£Øدثه طه Øسين ÙÙŠ Ù†Ùسه Øين كان طالباً ÙÙŠ الجامعة يستمع إليه وهو يشكّك بنبرته الساخرة ÙÙŠ كل شيء، يقول شاكر مثلاً: “ومضت سÙنون، Øتى دخلت٠الجامعة، وسمعت٠ما يقوله الدكتور طه ÙÙŠ كتابه (ÙÙŠ الشعر الجاهلي) الذي رجّ Øياتي رجّاً شديداً زلزل Ù†Ùسي … ÙÙوجئنا جميعاً بالدكتور طه، وبصوته الجهير، وبألÙاظه العذبة، وبØسن تعبيره عن مقاصده، ثم بإنكاره صØØ©ÙŽ الشعر الجاهلي … وأنا ÙˆØدي من بين جميع زملائي تجرّعت٠الغيظ بØتاً، ووقعت٠ÙÙŠ ظلام٠يÙÙضي إلى ظلام، ÙˆÙÙŠ Øيرة٠تجرّني إلى Øيرة، وهالني هذا الطعن الجازم ÙÙŠ علماء أمّتي، ÙˆÙÙŠ رÙواتها، ÙˆÙÙŠ Ù†ÙØاتها، ÙˆÙÙŠ Ù…Ùسّري القرآن ورÙواة الØديث، وبقيت٠أتلدّد يميناً وشمالاً زمناً متطاولاً “([1]) .
ويص٠شاكر ÙÙŠ آخر مقاله (المتنبي ليتني ما عرÙته) هذه الÙترة العصيبة من Øياته، وكي٠وقع ÙÙŠ “مØنة قضية الشعر الجاهليâ€ØŒ وكي٠تجرّع أهوالها التي كادت تÙÙضي به إلى الهلاك، يص٠هذه المØنة وبينه وبينها خمسون سنة، ولكن سخونة الوص٠وØرارة التعبير تÙشعرك بأنه يتØدث عن تجربة ما تزال Øيّة متوقّدة ÙÙŠ داخله، وكأن مرور السنين الطويلة لا يزيدها إلا تلظّياً: †Ùمنذ خمسين سنة قذÙتني القواذ٠ÙÙŠ المعمعة، Ùأنا أخوض الغمرات ÙÙŠ قضايا الÙكر والنظر، وأطأ على أشواك الاختلا٠والتناقض، وتتخطّÙني خطاطي٠الشكوك والريب، وأق٠على Ø´Ùا ØÙرة من النار، لو زلّت بي قدم لهويت٠على نار لا قرار لها سبعين خريÙاًâ€([2]).
ولا يملّ Ù…Øمود شاكر من تكرار الإشارة ÙÙŠ معظم مؤلÙاته إلى هذه العشْرية المظلمة من Øياته: “اعلمْ أني قضيت٠عشر سنوات من شبابي ÙÙŠ Øيرة زائغة، وضلالة Ù…Ùضْنية، وشكوك ممزÙّقة، Øتى Ø®ÙÙت٠على Ù†Ùسي الهلاك، وأن أخسر دنياي وآخرتي، Ù…ÙØتقÙباً إثماً يقذ٠بي ÙÙŠ عذاب الله بما جنيت، Ùكان كلّ همّي يومئذ أن ألتمس يصيصاً أهتدي به إلى مخرج ÙŠÙنجيني من قبر هذه الظلمات المطْبÙقة عليّ من كل جانبâ€([3]).
Ùهل اهتدى إلى المخرج من هذه الظلمات؟ هل تجاوز تلك الØيرة الزائغة؟ هل نجا بنÙسه من الوقوع ÙÙŠ الهاوية؟ عن هذه الأسئلة يجيب Ù…Øمود شاكر: “نعم، قد نجوت٠قديماً -بØمدالله وبرØمته- من غوائله، ولـمّا أكَدâ€([4]). ولك أن تق٠طويلاً عند الجملة الأخيرة من كلامه: “ولـمّا أكدâ€ØŒ Ùهي التي تكش٠لك لماذا يتØدث Ù…Øمود شاكر عن هذا (الماضي) دائماً، وكأنه Øاضر مستمر ومتجدد أبداً. نعم، هو ممتنّ لسلامته المستردّة بعد طول غياب، ولكنه مدرك أيضاً أنها سلامة أسيÙØ© لا تÙارقها ذكريات الغرق، أو كما يقول: “وسلمت٠-بØمده سبØانه- بعد مخالطة العطبâ€([5]).
2-توابع الزلزال:
أمّا لماذا كان لقضية أدبية مثل قضية (التشكيك ÙÙŠ صØØ© الشعر الجاهلي) كل هذا التأثير المزلزÙÙ„ ÙÙŠ Ù†Ùس شاكر، والذي دÙعه إلى قطع دراسته ÙÙŠ الجامعة، ثم إلى الهجرة من مصر بالكلية؟ Ùإن ذلك راجع إلى المآلات اللازمة التي كان يرى أنها تÙÙضي Øتماً إليها: “مØنة الشعر الجاهلي، Øين أخذتني قديماً، ÙقذÙتْني قذÙاً ÙÙŠ الأمر المخو٠المهوب، الذي تنخلع عنده القلوب، وهو: إعادة النظر ÙÙŠ شأن إعجاز القرآنâ€([6]).
ولعله يقصد أن نس٠الشعر الجاهلي من الوجود يعني Øرق الوثيقة الأهمّ التي تÙظهر تÙÙˆÙّق الجيل الذين تنزّل عليهم القرآن، وتØدّى بلاغتهم الÙائقة ببلاغته المعجÙزة، “لأن أصØاب هذا الشعر الجاهلي هم الذين Ù†Ùزّل عليهم القرآن العظيمâ€([7])ØŒ Ùإذا زالت هذه الوثيقة الشعرية البليغة، Ùما الذي يجعل الأجيال اللاØقة تسلّم بتØقق الإعجاز ÙÙŠ مناطه؟ أي أن اطّراد الإقرار بإعجاز القرآن عند الأجيال اللاØقة مبنيّ على الإقرار بأن الجيل الذي تنزّل عليه القرآن هو الجيل العربي الأبلغ، Ùإذا كان قد عجز عن Ù…Ùجاراة بلاغة القرآن، ÙÙ…ÙŽÙ† بعده من الأجيال سيكون أكثر عجزاً.
هكذا -Ùيما يبدو- تصوّر Ù…Øمود شاكر العلاقة التاريخية الوثيقة بين الشعر الجاهلي وإعجاز القرآن، متأثراً ببعض البلاغيين المتقدمين، وإن تØÙّظ على استعمالهم تعبير (الإعجاز)ØŒ Ù…Ùضّلاً تعبير (الآية)ØŒ لأسباب يطول شرØها([8]).
3-ÙلسÙØ© المØنة:
ÙÙŠ Ù…Øطات معينة من Øياته، وأمام إلØØ§Ø Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¦Ù„Ø© والتعليقات Øول أسباب هذه الصدمة العنيÙØ© التي تبدو للآخرين أضخم بكثير من باعثها، سيØاول Ù…Øمود شاكر أن ÙŠÙÙلس٠مØنته الذاتية، ويضع لها إطاراً عاماً مستمداً من بعض الملابسات التي Ø£Øاطت بتجربته ÙÙŠ الجامعة، ÙيتØدث عن (Ùساد الØياة الثقاÙية) التي ØªØ³Ù…Ø Ù„Ù„ÙƒØ¨Ø§Ø± أن يسطوا على بØوث الآخرين وينسبوها إلى أنÙسهم، كما صنع طه Øسين Øين استمد كثيراً من مقولاته التي أسس عليها كتابه (ÙÙŠ الشعر الجاهلي) من بØØ« سابق للمستشرق البريطاني مرجليوث كان قد نشره بعنوان (نشأة الشعر العربي)ØŒ ثم يتناهى خبر هذا السطو المكشو٠-ÙÙŠ نظر شاكر- إلى الجامعة وأساتذتها، Ùلا ÙŠØرّك Ø£Øد منهم ساكناً تجاه هذا الإخلال المنهجي الكبير الذي وقع Ùيه زميلهم، وهو ما Øدا بشاكر إلى العزو٠النهائي عن الدراسة ÙÙŠ جامعة٠بهذا المستوى من الÙساد والتدليس([9]).
ولكن هذه القضية الثقاÙية والأخلاقية تظل -على أهميتها- أعجز من أن تÙسر “الغمرات†الخانقة التي Ø£Øاطت بهذا الشاب، Ùˆâ€Ø®Ø·Ø§Ø·ÙŠÙ الشكوك†التي اجتاØت قلبه الغض، Ùˆâ€Ù‚بر الظلمات†الذي أطبق على صدره، منذ استمع إلى Ù…Øاضرات طه Øسين ÙÙŠ الجامعة.
ÙÙŠ الواقع لقد هاله أن يرى هذا الأستاذ المصري (بل الصعيدي مثله) الذي تربطه به صÙلات ممتدة، ويعر٠ألمعيته وتأسيسه الأزهري، وتضلّعه من التراث، ويعر٠أيضاً أنه درس قبله على يد الشيخ Ù†Ùسه الذي يدرس شاكر عنده ويقدّره كثيراً، وهو الشيخ سيد المرصÙÙŠØŒ ومع هذا كله تصل به الجرأة المستØدثة إلى أن يهزّ العلْم القديم هزاً عنيÙاً دون أن ÙŠÙبالي، بل وأن يرى أن (المنهج) الØديث يستدعي أن ÙŠÙقلَب العلْم القديم رأساً على عقÙب، وألّا يبقى منه إلا أقلّه، وقد ينتهي إلى تغيير التاريخ، أو ما اتÙÙ‚ الناس على أنه تاريخ([10]) !
4-العودة إلى الذات:
Ùماذا كان موق٠مØمود شاكر من هذا (الزلزال) الذي أصابه به طه Øسين؟
لقد اتخذ الموق٠الذي يجب أن يتخذه أيّ عقل مستقل لا ÙŠÙسلم Ù…Ùقْوده لأØد، وإنما يسبÙر أبعاد ما يسمع ويقرأ، ويخلص من الØاضر إلى الغائب، ومن الجليّ إلى الخÙيّ، ويتجاوز انتÙاش الدعوى إلى امتØان البرهان، ثم يرصد القرائن المتماثلة مهما تباعدتْ، كما يميّز بين الظواهر المتباينة وإن تداخلتْ جذورها، وتشابكتْ Ùروعها، وكي ÙŠØقق شاكر هذا (السبْر) المتأنّي الدؤوب كان عليه أن يخوض رØلة طويلة ÙÙŠ مصنÙات الأقدمين -بشتى علومها- وكان من لوازم الاستعداد لهذه الرØلة أن ÙŠØتجب عن Ù…Øيطه المألو٠ويعتزل ضجيجه وصوارÙه، وقد كان.
وبعد سنوات عاد Ù…Øمود شاكر من هذه الرØلة الممتدة وهو أصلب عوداً وأقوى شكيمة، وأشد عناداً وضدّية للزلزال وصاØبه، لاØقاً سيتذكر Ù…Øمود شاكر أنه استهلّ هذه الرØلة الطويلة بقراءة متأنّية لدواوين الشعر العربي ومجاميعه، لتنعط٠القراءة بعد ذلك Ù†ØÙˆ أهمّ الØقول المعرÙية ÙÙŠ التراث، متلمّساً ÙÙŠ هذه النصوص جميعاً Ø±ÙˆØ Ø§Ù„Ø¹Ø±Ø¨ÙŠ ونÙسغ اللغة الجامعة: “كلّ إرث آبائي وأجدادي كنت٠أقرؤه على أنه إبانة منهم عن خبايا أنÙسهم بلغتهم، على اختلا٠أنظارهم وأÙكارهم ومناهجهمâ€([11]).
وكان نتيجة هذا التطوا٠الطويل أن تبدّتْ له أخيراً Ù…Ù„Ø§Ù…Ø Ø§Ù„Ø·Ø±ÙŠÙ‚ØŒ Ùكان (ما قبل المنهج) هو الخطوة الأهمّ ÙÙŠ سبيل التØقق، للوصول إلى المنهج التراثي الأصيل، وكان (التذوّق) الناقد المدقق هو أبرز متّكأ يمكن أن ÙŠÙستمسك به ويÙعتمد عليه لاستنباط معالم هذا المنهج، ولتطبيقه على النصوص ÙÙŠ آن٠معاً.
هكذا يبدو أنه لولا طه Øسين ما كان Ù…Øمود شاكر الذي نعرÙه، لا بمعنى أن طه Øسين هو الذي صنع Ù…Øمود شاكر، وكوّن Ù…Øصوله العلمي، بل بمعنى: أن Ø£Ùكار طه صادÙتْ من شاكر قلباً غضّاً Ùأوقدتْ جذوته، وعقلاً موّاراً ÙاستÙزتْ كبرياءه، ونÙساً مطمئنة إلى ما لديها، Ùأقلقتْها وأÙزعتْها، ودÙعتْها إلى الاستقراء الجذري للأصول، بغية الوصول إلى المنهج التراثي الخبيء الذي يوØّد شتات العلوم، Ùكانت “رØلة طويلة جداً، وبعيدة جداً، وشاقّة جداً، ومثيرة جداًâ€([12]).
هذا على الرغم مما يشÙوب Ø´Ø±Ø Ø´Ø§ÙƒØ± المطوّل والمكرر لهذا (المنهج) التذوّقي الذي عÙني به من عÙسر ÙÙŠ الاستبانة، وضبابية ÙÙŠ الإبانة ÙŠÙقر شاكر Ù†Ùسه بهما إذْ يقول “Ùأنا Ø£Ùوثر اليوم أن أعاود السير Ùيه ÙˆØدي، بيني وبين Ù†Ùسي، لأني أخشى أن تكون معالمه عندي قد درستْ وامّØتْ، وخÙÙŠ عني مَدبÙÙ‘ أقدامي قديماً Ùيه، وتهدّمتْ بعض الصÙّوى التي كنت٠نصبتÙها مناراً Øيث سرت، لكي أهتدي بها وأستدلّ على مذاهبي التي بلغتْ بي يومئذ٠طريقاً قاصداً، كان لي موئلاً ومÙازاً ونجاةً وسلامة، ولذلك Ùأنا أخشى عليك أن تكون لي Ùيه صاØباًâ€([13]).
بالإضاÙØ© إلى اÙتقار هذا (المنهج) الشاكري إلى الأدوات الإجرائية المنظّمة التي تكÙÙ„ تماسكه وتيسّر استثماره، عÙوضاً عن الاعتماد على إطلاقات إنشائية تÙخيمية عصيّة على التطبيق.
ومع كل (اكتشاÙاته) التراثية التي أعادت الطمأنينة إلى Ù†Ùسه، والرØلة الطويلة التي قطعها للوصول إلى رؤيته المستقلة، والمنهج الخاص به، ظلّ Ù…Øمود شاكر ÙŠØتÙظ بهذه المساÙØ© المØسوبة من الØذر القلÙÙ‚ والهيبة المتغلْغلة تجاه معلمه Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠÙ…ØŒ مع النأي بنÙسه –ÙÙŠ الوقت ذاته- عن Ø£Ùكار طه Øسين ومواقÙÙ‡.
5-دÙاعاً عن (القوس العذراء):
استمرّ طه Øسين ÙŠÙناك٠شيوخ العلم المØاÙظين ذوي الطراز القديم، مبشّراً ببزوغ (عصر الأنوار) العربي المتØرر من سطوة التقاليد العتيقة، وهو التØرر Ù†Ùسه الذي رأى Ùيه Ù…Øمود شاكر Ø£ÙˆØ¶Ø Ø¯Ù„ÙŠÙ„ على (Ùساد الØياة الثقاÙية) ÙÙŠ عصره ومسارها المنÙلت الأهوج، بعيداً عن استيعاب الأصول.
واستهان طه Øسين بالشعر الجاهلي، وشكّك ÙÙŠ صØØ© نسبته لعصره، Ùصار توثيق هذا الشعر وتعظيمه -إلى ما يقارب التقديس Ø£Øياناً- ركناً أساسياً ÙÙŠ المشروع العلمي لمØمود شاكر، بل غدتْ عظمة التراث الإسلامي كله مبنيةً على الإقرار الأوليّ بØقيقة الشعر الجاهلي وعظمته: لغةً، وأدباً، وبلاغة([14])ØŒ وبعد أن ملأ يده بمنهجه التذوقي الذي مكّنه من تمييز السمات الخاصة بالشعر الجاهلي، لم يعد لأØاديث طه Øسين المشكّكة Ùيه أيÙÙ‘ قيمة علمية عنده، إذْ “لم تزد قطّ على أن تكون ثرثرة Ùارغة، كما استيقنت٠ذلك Ùيما بعدâ€([15]).
وتهوّر طه Øسين Ù…Ùراراً ÙÙŠ إصدار Ø£Øكام متعجلة على التاريخ الإسلامي والثقاÙØ© العربية القديمة، والتقليل من أصالة الأÙكار عند أعلام التراث المشهورين، Øتى ليبدو وكأنهم مجرّد مرايا عاكسة للثقاÙØ© الهيلينية المهيمنة على العالم القديم، Ùجعل Ù…Øمود شاكر وكْده أن ÙŠÙØامي عن التراث العربي ÙƒØارس٠لبوّابته، وأن يعظّمه ÙÙŠ Ù†Ùوس Ù‚Ùرائه إلى Øدّ الترهيب، وأن يجأر بالشكوى المرّة من شيوع (داء الاستهانة) ÙÙŠ العصر الØديث، ثم أن يتندّر بعد ذلك وقبله من سذاجة الثقة المÙرطة لدى بعض الكتّاب المعاصرين عند تناولهم نصوص الأقدمين الØاذقة، وعبثهم الطÙولي المتطاول على كنوز معارÙهم المرصودة.
ورأى طه Øسين أن (مستقبل الثقاÙØ© ÙÙŠ مصر) إنما يتأسس عبر انتمائها لثقاÙØ© البØر الأبيض المتوسط: هكذا كانت دائماً: عبر Ø§Ù„ØªÙ„Ø§Ù‚Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¨Ø§Ø¯Ù„ بينها وبين اليونان، وهكذا يجب أن تكون: عبر الإقرار بـ(الجوهر الواØد) الذي ينظÙÙ… العقل الأوروبي بالعقل المصري! وأن من الأوهام التي لا يعر٠من أين جاءت: اعتقاد المصريين أن ثقاÙتهم شرقية، وليست غربية، Ùهل الصين واليابان والهند والشرق الأقصى البعيد أقرب إلى مصر من جيرانها الأوروبيين؟ وجواب هذا السؤال –عند طه- لا ÙŠØتاج إلى بيان([16]).
ÙÙŠ المقابل رأى Ù…Øمود شاكر أن امتداده الوثيق هو امتداد ثقاÙÙŠØŒ لا مكاني، وأن مصريّته مؤسسة على عروبته، Ùهو عربي أولاً قبل أن يكون مصرياً، لأن العروبة هي لغته التي يتكلم بها، وثقاÙته التي ÙŠÙكر من خلالها، وإرثه الØضاري الذي ينتمي له ويÙØامي عنه، وأن هذا الإرث الØضاري مخال٠تماماً للإرث الØضاري الأوربي: معتقداً، وقÙيَماً، وتاريخاً، وهÙويّة، وأن مستقبل أيّ ثقاÙØ© إنما ÙŠÙؤسَّس بالاستناد إلى ماضيها، أي أن ينشأ نشأة طبيعية من داخل الثقاÙØ©ØŒ لا أن ÙŠÙÙرض من الخارج عليها، وأن الوعاء العظيم الذي يستوعب مستقبل الثقاÙØ© كما استوعب من قبل ماضيها هو: اللغة العربية، وتØديداً لغة العرب الجاهليين، لأن كل ما جاء بعدها مبنـيٌّ عليها([17]).
6-عقابيل Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠÙ…:
ومع هذه المواق٠المستقلة كلها ظلتْ جرأة طه Øسين -التي تصل Ø£Øياناً إلى Øد التهوّر- ÙÙŠ مساءلة الأصول والمسلّمات الأدبية والتاريخية، وقد اكتسبتْ زخماً مضاعÙاً بتناسل التلاميذ والـمÙريدين والمؤيدين، ظلت هذه الجرأة المستهينة هي داء Ù…Øمود شاكر الوبيل، والصخرة الجاثمة على صدره، والمشرط الأثيم الذي ينكأ جرØÙ‡ القديم.
كان Ù…Øمود شاكر ÙÙŠ الواقع يجاهد طوال Øياته، وبمشقة ظاهرة هذا (الطه) المتشكّك اللعوب، المتسرب Ùيه Øتى الأعماق، ويراه ماثلاً ÙÙŠ كل مستهين٠بالتراث ومجترئ عليه، وقد دÙعته هذه المجاهدة المتطاولة ليمدّ عنقه أكثر، Ù…Øاولاً تأريخ هذا التشكيك، ومتتبعاً الجذور الأولى Ù„Ùساد الØياة الأدبية -بØسب تعبيره- منذ عصر (النهضة)ØŒ وصولاً إلى وقته الراهن، ومØللاً “داء الاستهانة†الذي عص٠بتراثنا العربي على يد كبار الكÙتّاب بدءاً من الإمام Ù…Øمد عبده، وتلامذته، وصولاً لقواÙÙ„ الكتّاب اللاØقين([18]).
وهَوناً ما كان Ù…Øمود شاكر يواجه اندÙاعات معلّمه الجَموØØŒ وإنك لتعجب: كي٠يستØيل هذا الغاضب أبداً من كل ما لا يلائمه، العني٠غالباً مع من يخالÙÙ‡ إلى Ù…ÙÙاوض مهذّب لا ينسى لوازم التوقير والاØتشام Øين يناقش أطروØات طه Øسين مهما اختل٠معه، هاهو ذا مثلاً يستهلّ Øديثه عن كتاب (الÙتنة الكبرى) لطه Øسين بعد سنوات طويلة من (منعط٠الجامعة)ØŒ Ùيقول: “وأنا أعر٠للدكتور مكانه من العلم والتØقيق، ÙˆØسن تأتّيه ÙÙŠ تخريج الكلام، Ùمن أجل ذلك أيقنت٠أنه سيملأ هذا الكتاب علماً… وقلت٠لنÙسي قبل أن أتجاوز الكلمة الأولى من الكتاب: إن طه خير من يصوّر للناس هذه الأØداث المختلطة المضطربة، وخير من يهديهم ÙÙŠ Ø´Ùعابها إلى Ù…Ùصل الرأي ومقطع البيانâ€([19]).
وبعد أن يناقش شاكر بعض أطروØات الكتاب يعود Ùيقول: “وهذه الخمسة أشياء كنت٠أستØÙŠ أن Ø£Øدّث الدكتور بها أو أناقشه Ùيها، لأنها من Ø§Ù„ÙˆØ¶ÙˆØ ÙˆØ§Ù„Ø¬Ù„Ø§Ø¡ بØيث لا تخÙÙ‰ على رجل مثله خرّاج ولّاج، بصير بالعلم Ø£Øسن البصرâ€([20]).
تقرأ هذا الكلام: أوله، وآخره، Ùيثير Ùيك التساؤل عن سرّ هذا التودد والاØتÙاء، ومبعث ذلك التوقير والتبجيل الذي ÙŠÙكنّه شاكر لطه، مهما تباعدتْ Ø´Ùقّة الخلا٠بينهما ÙÙŠ الرأي، ومهما بلغتْ خطورة القضية التي يناقشها معه، وهي هنا: (الÙتنة الكبرى) بقضّها وقضيضها.
نعم، تابع Ù…Øمود شاكر مقالاته لتÙنيد بعض ما ذكره طه Øسين ÙÙŠ هذا الكتاب بدأب علمي وتØقيق لاÙت، ولكن هذا كله لم يمنعه من إظهار التوقير والتقدير لطه Øسين كلما سنØتْ له الÙرصة: المرة تلو الأخرى، وهو التوقير الذي لم ينسَ شاكر إظهاره ÙÙŠ مناسبة أخرى، Øين كان ÙÙŠ أوج معركته الØامية مع لويس عوض، دÙاعاً عن أصالة أبي العلاء المعري، ÙØين يعرض هناك لذكر طه Øسين لا ينسى أنه “أستاذنا الكبيرâ€ØŒ وأن يدعو له بأن: “أطال الله بقاءهâ€ØŒ وأن ÙŠÙثني على ما يتسم به أستاذه القديم من “Øبّ الأوبة إلى مقالة الØÙ‚â€([21]).
ومع هذا التوقير لطه Øسين ظلّ Ù…Øمود شاكر Ù…ØتÙظاً ÙÙŠ الوقت Ù†Ùسه بØقه الدائم ÙÙŠ التعبير عن اختلاÙÙ‡ معه، ولكن دون الوصول Ù„Øدّ الخصومة، على الرغم من أن هذا الخلا٠-كما ÙŠØµØ±Ø Ø´Ø§ÙƒØ± ÙÙŠ موضع آخر-: “خلا٠بعيد الجذور، يبلغ Øدّ التباين الكامل ÙÙŠ الأصولâ€([22]).
ولعل مقاله المعنْون بـ(لا تسبÙّوا أصØابي) هو من المواضع القليلة التي تجرّأ Ùيها Ù…Øمود شاكر على نعت طه Øسين بأوصا٠Øادّة، وإن لم يذكر اسمه، Ù…ÙكتÙياً بالإشارة إليه بأنه “صاØب كتاب الÙتنة الكبرىâ€([23])ØŒ كما تضمنتْ مقالاته -التي داÙع Ùيها عن أصالة كتابه (المتنبي) عبر موازنته بكتاب طه Øسين عن المتنبي- أوصاÙاً Øادّة أخرى([24]).
ومØمود شاكر يجيب بنÙسه عن سبب هذه الÙلتات المتناثرة تجاه أستاذه القديم، ÙˆØدود Ù…Ùراده منها Ùيقول: “كلّ ما قلت٠من ذلك Ù…Øدود بمواضع نقدي لنصوص من كلامه، لا ينسØب شيء منه انسØاباً مطلقاً على كل كلام٠يكتبه، ولا على شخصه، من Øيث هو أستاذ من الأساتذة الكبارâ€([25]).
7-نزهة مع الغضب:
وإذا كان Ù…Øمود شاكر يتوخى -إجمالاً- الأدب والترÙّق مع طه Øسين، والتخÙÙŠÙ -بقدر ما ÙŠÙسعÙÙ‡ الطبع- من بدوات التعالي والغضب، Ùإن هذه الكÙْكÙØ© الصبورة لا تÙبذل مع أي Ø£Øد، وقد نستثني أسماء قليلة جداً بدا على شاكر تقديره لها علمياً، أو Ù…Ùراعاته لسابق معرÙته بها على الرغم من إعلانها الاختلا٠معه، مثل الناقدين: Ù…Øمد مندور، وعبدالعزيز الدسوقي، والمØقق سيد صقر.
عدا هذه الاستثناءات القليلة، Ùإنه كثيراً ما كان ÙŠÙصلي مخالÙيه بأسنّة من لهب Øين يبدو له أنهم خالÙوا ما يراه الصواب كله، ولن أق٠مطولاً هنا عند ما صنعه مثلاً مع لويس عوض ÙÙŠ كتابه (أباطيل وأسمار)ØŒ Ùهي معركة لاهبة يستØÙ‚ عوض (بعض) ما أصابه من شَررها، لتعالمه ÙÙŠ التراث ومصادر التاريخ على غير علم.
كما لن Ø£ÙÙيض ÙÙŠ الØديث عن الأسلوب المتعالي والمستخÙÙÙ‘ الذي ناقش به Ù…Øمود شاكر اعتراضات كل من: شوقي ضيÙØŒ ومØمد رجب البيومي عليه([26])ØŒ Ùهذا هو الأسلوب المÙضّل لديه عند اØتدام الخصومة على صÙØات مجلة (الرسالة).
ولكن مما يلÙت النظر Øقاً ذلك الاندÙاع المØموم الذي أصاب Ù…Øمود شاكر ÙÙŠ السنوات القليلة التي أعقبتْ نشر بØثه الأول عن المتنبي عام ١٩٣٦م، Ùصار يتتبع Ùيها -بØماسة الشباب- كل كاتب يدرس المتنبي، بوصÙÙ‡ (سارقاً Ù…Øتملاً) منه، وقد خلص من هذا التتبع إلى أن بØثه استØال ØÙمى مستباØاً لكثير من الدارسين الذين يعتمدون على (استعارة) الأÙكار Ùˆ(تلخيصها) دون نسبتها إلى صاØبها الأØقّ بها، ولكنه ركّز على شخصين مهمين، وهما: عبدالوهاب عزام، وطه Øسين، اللذان سرقا منه -بØسب تعبيره- أهمّ ما ÙÙŠ كتابيهما عن المتنبي من Ø£Ùكار، ولن يبقى ÙÙŠ الكتابين بعد ذلك سوى تخليط وثرثرة لا طائل من ورائهما([27]).
كما أن هذا الاندÙاع المØموم Ù†Ùسه هو الذي جعله لا يصبر على أي نقد ÙŠÙوجّه لبØثه، ولا ÙŠÙسلّم بوقوع أي خطأ أو سهو Ùيه، مهما بلغ هذا النقد من الرزانة والاتساق والاتزان، كالنقد الموضوعي المتمهّل الذي كتبه سعيد الأÙغاني عن مسألة (علوية المتنبي) التي أسس شاكر بØثه عليها، وقد نشر سعيد هذا النقد ضمن بØØ« مستقل نشره ÙÙŠ مجلة (الرسالة)ØŒ ثم تتابعتْ مقالاته ÙÙŠ المجلة Ù†Ùسها، تجاوباً مع ردود شاكر عليه([28]).
بل بلغت الØماسة بشاكر تلك الأيام إلى أن يرى Ù†Ùسه مقصوداً بأي إشارة عامة يذكرها Ø£Øد الكتّاب عندما يتØدث عن دراسة٠ما Øول المتنبي، كما يشÙÙŠ بذلك مقاله المتعجل ÙÙŠ الردّ على الشيخ الأزهري المعرو٠علي عبدالرازق، Ùقد اÙترض Ùيه أنه هو المقصود بÙكرة عامة وعابرة وردتْ ÙÙŠ مقال لعبدالرازق، وهي أبعد ما تكون عنه وعما جاء ÙÙŠ كتابه([29]).
ولكنّ بوادر الØميّة والغضب عند شاكر تبدو أكثر غرابة Øين تتعلق بمسائل تÙعد من أقرب المسائل (العلمية) اØتمالاً لقبول الاختلاÙØŒ ومدعاةً للتريث الوقور والمتواضع عند مناقشتها، كاختلا٠الباØثين ÙÙŠ الوسائل الأنجع لأداء التØقيق العلمي لكتب التراث على Ø£Ùضل وجه، ورصد بعضهم على بعض Ù‡Ùوات علمية لا يخلو Ø£Øد من الوقوع Ùيها، وتأمّلْ مثلاً كي٠تعامل Ù…Øمود شاكر بغضب Ø¬Ø§Ù…Ø Ù…Ù‚Ø±ÙˆÙ† باستخÙا٠وسخرية وهو يردّ -ÙÙŠ مقدمة تØقيقه لكتاب ابن سلام الجمØÙŠ- على اعتراضات وجيهة جداً لأساتذة Ù…Øققين من أبرزهم: علي جواد الطاهر، Ùقد وص٠شاكر مقال علي الطاهر ÙÙŠ نقد تØقيقه بأنه “ÙÙŠ الØقيقة كدÙاتر اليهودي كما ÙŠÙقال ÙÙŠ المثلâ€([30])ØŒ وأنه كان ينوي إهمال ما كتبه “هذا الآتيâ€ØŒ وتجنÙّب الرد عليه، لولا أنه أراد -ÙÙŠ نغمة أستاذية معهودة ÙÙŠ شاكر- أن ÙŠÙبلي “عذراً ÙÙŠ إرشاد الأجيال الجديدة التي ÙƒÙتÙب عليها أن تعيش ÙÙŠ رَدَغة هذه الØياة الأدبية الÙاسدة التي أطبقتْ بÙسادها على الأÙمّة العربية والإسلامية… والسكوت عن هذه الردغة مشاركة ÙÙŠ آثامها وجرائمهاâ€([31]).
وهكذا يكÙÙŠ أن تكتب معترضاً على بعض اجتهادات Ù…Øمود شاكر ÙÙŠ التØقيق، ومنها: إقØامه كلمة (ÙØول) ÙÙŠ عنوان كتاب ابن سلام: (طبقات الشعراء)ØŒ لأسباب غير Ù…Ùقنعة، أو أن تÙدقّق ÙÙŠ بعض النقول التي توسّع شاكر ÙÙŠ إضاÙتها للكتاب، أو أن تÙبدي رأيك ÙÙŠ بعض مصادره التي اعتمد عليها ÙÙŠ التØقيق، تكÙÙŠ هذه الاعتراضات العلمية ÙˆØدها Øتى يكون صاØبها Ø£Øد الشواهد على “الØياة الأدبية الÙاسدةâ€ØŒ وأن ÙŠÙشنَّع -ÙÙŠ ردّ انتقامي صريØ- على بعض أخطائه اللغوية، وأن ÙŠÙستهزَأ به ÙÙŠÙوص٠بأنه “يقرأ غير ما أكتب، ثم ÙŠÙهم غير ما يقرأ، ثم يكتب غير ما ÙŠÙهمâ€([32])ØŒ وبأن كلامه “ركيك ÙˆÙاسد، وغير صØÙŠØØŒ ومدخل ÙÙŠ الهذيانâ€([33])ØŒ ثم أن يخلص شاكر بعد هذه المناقشة اللجوجة الممتدة إلى أن مقال علي الطاهر الذي أعاد نشره: “عبث Ù…Øض، واستهزاء بالقرّاء، وإهدار لقيَم الأشياء، وغشّ للمجلة التي نشرتْهâ€ØŒ وأنه: “عمل سيء، ÙŠÙغري به قصد سيء، يخرج صاØبه من Øيّز الأمانةâ€([34]).
والمغزى من هذه (النزهة الغضبية) عند شاكر أن نقول: إنك قلّما تجد مثل هذه النبرة المتعالمة والمتأÙÙ‘ÙØ© عنده Øين يتØدث إلى طه Øسين، هذا مع تنوÙّع ردوده على كتابات طه، وطول عهده بها، وكثرة مؤخذاته عليه Ùيها.
ÙÙŠ مقدمة كتابه (المتنبي)ØŒ ÙˆÙÙŠ مواضع أخرى من مؤلÙاته Øاول Ù…Øمود شاكر أن يقدم بعض الأسباب التي كانت تمنعه من مجابهة طه Øسين بشراسة تتناسب مع ما يجده ÙÙŠ Ù†Ùسه من ثورة عارمة تجاه Ø£Ùكاره، وبخاصة ÙÙŠ أثناء تدريسه له، Ùهو أولاً أستاذه ÙÙŠ الجامعة، وهو ثانياً صاØب Ùضل عليه، Ùهو الذي Ø´Ùع له عند مدير الجامعة آنذاك (لطÙÙŠ السيد) كي يتجاوز التطبيق الØرÙÙŠ لنظام القبول الذي يمنع أي طالب ÙŠØمل شهادة القسم العلمي ÙÙŠ المرØلة الثانوية من دخول الكليات الأدبية، ثم إن بينهما ثالثاً صلات قديمة تجعله ينظر إليه دائماً كأخ٠أكبر له([35]).
هذه هي الأسباب التي ذكرها شاكر، ولكنه لم يذكر السبب الأهمّ الذي كان تأثيره يزداد رسوخاً مع الأيام، وهو ذلك الØذر المتوجس داخله من استعادة مشاعر شديدة التهيّج والانÙعال تجاه (ماض٠لا يمضي)ØŒ وتلك الهيبة النÙسية من المواجهة الطائشة مع Ø¬Ø±Ø Ø¹ØªÙŠÙ‚ لا يكاد يندمل.
8-رباعية Ù…Øمود شاكر:
كم يبدو Ù…Øمود شاكر آسÙراً عند Ù…ÙØبيه Øين يكون مجروØاً، وهل خلا من هذا الوص٠يوماً؟ وإذا لم يكن شاكر هو Ø£ÙˆØ¶Ø Ù…Ø«Ø§Ù„ على الإنسان العربي المعاصر Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø±ÙˆØ ÙÙŠ لغته ÙˆØضارته وقÙيَمه، ÙÙ…ÙŽÙ† يكون إذن؟ مجروØØ› بكل ما ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø Ù…Ù† جاذبية الألم ÙˆÙتنة المعاناة، ومن بين كتّابنا المعاصرين يبدو شاكر استثنائياً ÙÙŠ قدرته على استهواء قرائه واستقطاب مشاعرهم تجاهه، ونØÙˆ الموضوع الذي يعالجه، بأسلوبه الÙريد الذي يزاوج بين: التهويل، والازدراء، والتÙخيم، والصراØØ© الكاشÙØ©.
Ùأمّا التهويل Ùيظهر ÙÙŠ ذلك التهيّب القلÙÙ‚ الذي ÙŠÙبديه شاكر عند تناول كثير من الموضوعات، وبخاصة عند سبر المصطلØات والمÙاهيم، وتمييز الÙÙروق بين الألÙاظ المتقاربة، وما يزال ÙŠÙبدئ ÙÙŠ تهيّبه ويÙعيد Øتى ÙŠÙعديَ القارئ، ويملأ قلبه توجّساً وقلقاً ورهبة، وتطلّعاً –وهذه هي الثمرة- إلى القول الÙصل الذي يهدي إلى سواء السبيل. كما يتبدّى التهويل أيضاً ÙÙŠ إشاراته المتواترة إلى المخاطر المØدÙقة التي هي ÙÙŠ كثير من الأØيان مخاطر Øقيقية، ولكنها بقلم شاكر تبدو دائماً موشكة على الانÙجار والتشظي.
ولا أعني هنا أنه يصطنع هذا التهويل والتهيّب لمجرد التأثير ÙÙŠ القارئ وجذب اهتمامه، Ùالأقرب أنهما صÙتان طبيعيتان وملازمتان لشاكر منذ بداياته المتوجّسة مع الشعر الجاهلي، ثم مع نسب المتنبي، وانتهاءً بالسطور الأخيرة الوجÙلة والمرتجÙØ© التي كتبها قبل ÙˆÙاته عن إعجاز القرآن: “وكلما أردت٠ذلك، Ø£ÙØيط بي، يأخذني ما يأخذني من القلق والØيرة والتردد، هيبةً لما أنا Ù…ÙقدÙÙ… عليهâ€([36]).
وبهذا التهيّب الذي يضخّمه طبع التهويل عنده يمكن تÙسير Ùترات الصمت والانقطاع الطويل عنده عن الكتابة لسنوات ممتدة، Øتى يكاد ÙŠÙقد ثقته ÙÙŠ قلمه وقدرته على معاودة الكتابة، وانظر مثلاً Øديثه الاستهلالي المتلجْلج عن صدأ القلم وثقل Ù…Øمله عليه، والهÙوّة السØيقة التي تÙصله عنه بعد طول انقطاعه عن الكتابة، قبل بدء معركته مع لويس عوض ÙÙŠ (أباطيل وأسمار)([37]).
وبهذا التهويل الÙطري أيضاً يمكن تÙسير ما قدّمه ÙÙŠ كتابه (رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا)ØŒ ÙˆÙÙŠ مواضع أخرى من مؤلÙاته من قراءة خاصة للتاريخ العربي والإسلامي، مبنية على رصد سردي مشØون لمراØÙ„ الصراع مع الغرب الأوروبي، مع التركيز بخاصة على الأØداث الجسام التي واكبتْ ما ÙŠÙسمّى بـ(عصر النهضة) -وهي التسمية التي لا يرتضيها شاكر بالطبع- منذ اØتلال نابليون لمصر أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، ثم الاØتلال الإنجليزي بعده، وما عاصرَ ذلك وأعقبه من (تÙريغ ثقاÙÙŠ) للأجيال، بØسب تعبير شاكر([38]).
هذا عن سمة التهويل ÙÙŠ أسلوب شاكر، وأمّا سمة الازدراء المتأÙÙ‘Ù ÙÙŠØرّضها الواقع البائس المØيط به ومعظم (الÙاعلين) Ùيه، وهنا يأتي تعبيره المÙضّل الذي لا يكÙÙ‘ عن تكراره، Øول: (Ùساد الØياة الثقاÙية) الذي تØدّر -ÙÙŠ رأيه- من جيل (النهضة)ØŒ ثم استشرى ÙÙŠ جيله والأجيال اللاØقة له.
ولعل أبرز تجليات الازدراء التي ØªÙ…Ù†Ø Ù„Øديث شاكر جاذبية شديدة ورواجاً كبيراً عند قرائه ومÙريديه: ما ÙŠØرص على إظهاره دائماً من اعتزاز وترÙÙّع تراثيين مصØوبين بازدراء كبير تجاه كل ما هو غربي أو ما ينتمي لأوروبا، أي تلك “الرقعة الشمالية التي Ùيها هذا الهمج٠الهامجâ€([39])ØŒ وكثيراً ما يكرر شاكر هذه النغمة المتعالية -النادرة هذه الأيام- تجاه الغرب، خاصة عندما يتØدث عن الاستشراق وما كتبه هؤلاء المستشرقون (المجنّدون) من دراسات مغرÙضة عن التراث العربي والإسلامي، وهم لا يملكون الشروط الثلاثة اللازمة لاستيعاب هذا التراث: بلغته، وثقاÙته، وصدق الانتماء إليه([40]). وينسØب الازدراء الشاكري أيضاً على كل ما اصطنعه هؤلاء المستشرقون (الأعاجم المساكين) من رسوم شكلية وقواعد بالية ÙÙŠ (منهج التØقيق) لكتب التراث العربي([41]).
وبهذه السمة: سمة الازدراء المتأÙّ٠أيضاً يمكن تÙسير ولع Ù…Øمود شاكر بشعر أبي العلاء المعري وتزيينه أغلÙØ© بعض كتبه ومتونها بأبيات (شيخ المعرّة) المستخÙÙّة بالناس، والناقمة على كل شيء! وتعلÙّق شاكر بالمعرّي، واØتÙاؤه به، واستØضاره الدائم لأشعاره ÙˆØÙكَمه ÙŠØتاج ÙˆØده إلى وقÙØ© مستقلة، Ùهذا التراثي السلÙÙŠ لم يجد غضاضة ÙÙŠ مصاØبة المعري، والتغني الدائم بأشعاره، بل والمناÙØØ© عنه وعن أصالته ÙÙŠ معركة٠هي الأشهر والأكثر إيذاءً من بين معارك Ù…Øمود شاكر الثقاÙية، Ùقد قبÙÙ„ شاكر إذنْ صاØبه أبا العلاء المعري، متجاوزاً ما ÙÙŠ أشعاره –وبخاصة اللزوميات- من شكوكيات ÙˆØ¬Ù†ÙˆØ Ùكري، بينما لم يقبل شكوكية أستاذه طه Øسين، ÙˆÙÙŠ تأمÙّل هذا التباين بين الموقÙين يتبدى لك Ø£Øد الأسرار الشاكرية، ÙÙ…Øمود شاكر ÙŠÙولي تقديراً كبيراً للأصالة الذاتية والانتماء للثقاÙØ© العربية، وهذا ما يجسّده أبو العلاء المعري، Ùهو الشاعر المتمكن والأديب المتÙنن واللغوي المتبØÙّر، وهو أيضاً العربي الخالص ÙÙŠ ثقاÙته ورؤيته، وإن شابَ هذه الرؤية بعض Ø§Ù„Ø¬Ù†ÙˆØ Ø§Ù„Ø°Ø§ØªÙŠØŒ أمّا طه Øسين، Ùشكوكه Ù…Ùجتلبة من الخارج، ومÙØاكية لأبØاث المستشرقين، ومنهجه –كما ØµØ±Ù‘Ø ÙÙŠ كتابه- هو منهج الÙيلسو٠الÙرنسي ديكارت، أي أنه بمعيار شاكر: مجرد ناقل عن الغرب، ومقلÙّد لأساطينه.
ومن هنا نستطيع تÙسير السÙّخط العارم الذي ألـمَّ بشاكر Øين اطّلع على مقال٠للويس عوض اتكأ Ùيه على بعض المرويّات التاريخية، للقول بأن المعري تأثّر Ùكرياً براهب مسيØÙŠØŒ وبهذا انطلقت معركة (أباطيل وأسمار) التي شهدتْها الصØاÙØ© المصرية أواسط الستينات الميلادية، لقد آذاه هذا الربط (الØضاري) أشدّ الإيذاء، وكأنّ لسان Øاله يقول: Øتى تراثنا العريق وثقاÙتنا العربية الخالصة تريدون أن تÙشاركونا Ùيها، لتقولوا لنا: إنه ليس هناك ثقاÙØ© عربية Øية خالصة لكم، ÙÙ†ØÙ† موجودون Ùيكم من قبل ومن بعد ! ومن هنا أيضاً نعر٠لماذا كان شاكر يرÙض Ù…Ùهوم (الثقاÙØ© العالمية)ØŒ والإرث الإنساني المشترك، لقد رأى أن Ù…Øصّلته هي: الترويج للثقاÙØ© الغربية ÙˆØدها: ثقاÙØ© المنتصرين المهيمنين([42]).
وهذه العروبية التراثية هي ما ÙŠÙسّر لك أيضاً لماذا انØاز Ù…Øمود شاكر ÙÙŠ شبابه لمصطÙÙ‰ الراÙعي، دون عباس العقاد، وطه Øسين من جيل الشيوخ، مع أن الراÙعي كان أضع٠الثلاثة، وأقلَّهم قدرةً على إبداع الأÙكار والاØتجاج لها، وأكثرهم تكلÙÙ‘Ùاً ÙÙŠ الأسلوب وتزويقاً Ùارغاً للألÙاظ، Ùقد كان يكÙيه شرÙاً عند شاكر: التصاقه بالتراث وعشقه له، ومناÙØته الدائمة عنه.
وبهذه العروبية التراثية أيضاً يمكن أن Ù†Ùسّر لماذا كان Ù…Øمود شاكر غير منسجم مطلقاً مع النزعة التطهÙّرية التي سادت الأجواء Øيناً، واتخذت مواق٠ناشزة تجاه بعض الأعلام والشعراء القدامى، وسعتْ إلى Ù…Øاكمة المصنّÙات التراثية أخلاقياً ÙˆÙكرياً، لتقرر المقبول منها وغير المقبول، Ùقد هاجم شاكر أصØاب هذه النزعة بضراوة، ورأى أنهم ÙÙŠ ص٠واØد مع أعداء التراث والمستهينين به، أيّاً كانت بواعثهم وأهداÙهم.
وأمّا سمة التÙخيم عند Ù…Øمود شاكر Ùتتجلّى ÙÙŠ Øديثه المتكرر -الذي لا يخلو من Ù†ÙŽÙَس رسالي- عن المهمة الجليلة التي نذر Ù†Ùسه لأدائها، وعما يلاقيه من مشقة وعنت ÙÙŠ سبيل النهوض بهذه الأمّة الغاÙية، والمناÙØØ© عن تراثها العظيم، والإبانة عن المنهج الكلي الناظم لعلومها ومعارÙها: “Ùصار Øقاً عليّ واجباً أن لا أتلجلج، أو Ø£ÙØجÙÙ… أو Ø£ÙجمْجÙÙ… أو Ø£Ùداري، ما دمت٠قد نصبت٠نÙسي للدÙاع عن أمّتي ما استطعت٠إلى ذلك سبيلاً… ثم صار Øقاً عليّ واجباً أن لا Ø£Ùعرّج على بÙنيّات الطريق، إلا بعد أن أجعل الطريق الأعظم الذي تشعّبتْ منه واضØاً لاØباً Ù…Ùستبيناًâ€([43]).
وهذه الإشارة الأخيرة إلى (Ø§Ù„ÙˆØ¶ÙˆØ ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªØ¨Ø§Ù†Ø©) تقودنا إلى السمة الرابعة لأسلوب شاكر، وهي: الصراØØ© الكاشÙØ©ØŒ وبالاعتماد عليها خاضَ جميع معاركه مع خصومه، وكان ÙŠÙدÙلّ كثيراً بشجاعته الصريØØ© ÙÙŠ المواجهة وثباته الكاش٠ÙÙŠ مواطن التØدي.
أمّا غايته الكبرى التي كان يروم الوصول إليها ÙÙŠ كل قضية يتناولها Ùهي: Ø§Ù„ÙˆØ¶ÙˆØ ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªØ¨Ø§Ù†Ø©ØŒ وأمّا أسلوبه المÙضل لأداء (رسالته) الثقاÙية، Ùقد كان أيضاً: Ø§Ù„ÙˆØ¶ÙˆØ Ø§Ù„Ù…Ø¨ÙŠÙ† والصراØØ© الكاشÙØ©ØŒ وهو ÙÙŠ هذا يستجيب لتأصيله التراثي ورؤيته لطبيعة البيان العربي ÙÙŠ عصوره المزدهرة، وكي٠يستØÙ‚ (البيان) اسمه إن لم يكن واضØاً جليّاً لا لبْسَ Ùيه؟
ومن هنا لم يكن غريباً أن ينÙر شاكر من الأسلوب الرمزي ÙÙŠ التعبير، وأن يعدّ “اللجوء إلى الرمز ضرباً من الجÙبن اللغوي! Ùاللغة إذا اتسمتْ بÙسÙمة الجÙبن، كثÙر Ùيها الرمز، وقلّ Ùيها الإقدام على التعبير الصØÙŠØ Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø Ø§Ù„Ù…ÙْصØ… وأنا أستنك٠من الرمز ÙÙŠ العربية، لأن للعربية شجاعةً صادقة ÙÙŠ تعبيرها، ÙˆÙÙŠ اشتقاقها، ÙˆÙÙŠ تكوين Ø£ØرÙÙها، ليست للغة٠أخرىâ€([44])ØŒ ومن يجهر بهذا الرأي الباتّ الØاسم، لن يعبأ كثيراً بآراء اللسانيين المØدثين Øول المزالق العلمية للتورط ÙÙŠ المقارنة (الأخلاقية) بين اللغات.
وهذه المزاوجة الرباعية بين: التهويل، والازدراء، والتÙخيم، والصراØØ© الكاشÙØ© هي مزاوجة Ùريدة الإيقاع لا يتقنها سوى Ù…Øمود شاكر ÙˆØده، بصياغته الجزلة المصقولة، ومرجعيته التراثية الرØبة، ونكهة السخرية المتعالية التي يعر٠متى يلجأ إليها، للتنكيل بخصومه، أو الاستقواء على Ù…Ùارقات الواقع، مع قدْر غير قليل من التباهي اللغوي المتÙاصÙØØŒ Ùˆ(المتباصÙر بالغريب) كما عبّر مرة بشّار بن بÙرد ÙÙŠ وصÙÙ‡ لسلْم بن قتيبة([45])ØŒ وهذه كلها أسلØØ© أدبية ولغوية طالما استثمرها Ù…Øمود شاكر ÙÙŠ معاركه مع الخصوم، ÙˆÙÙŠ سعيه لاستقطاب المزيد من المؤيدين والـمÙريدين.
وقد تÙصاد٠كتّاباً آخرين تتّسم كتاباتهم ببعض هذه السمات الشاكرية، وخاصة التهويل والتÙخيم -كنجيب البهبيتي مثلاً- ولكنهم لا ينجØون Ù†Ø¬Ø§Ø Ø´Ø§ÙƒØ± ÙÙŠ الاستيلاء على Ù‚Ùرّائهم، والقدرة على استهوائهم بهذا (النمط الصعب) من البيان الرÙيع.
9-الشاكريÙّون ومعلّقات التبجيل:
لهذا كله لم يكن غريباً أن يكثر الأتباع المنبهرون بمØمود شاكر، ولكن Øين تتأمل صورة شاكر لدى الكثير منهم، تدرك إلى أيّ درجة يمكن أن يسيء الأتباع المتØمسون Ù„Øقيقة العالÙÙ… أو الكاتب، ÙÙ…Øمود شاكر عندهم هو: Øارس التراث، وشيخ العربية، وأستاذ الأجيال الذي يتمتع بصÙات مثالية لا تÙضاهى من: سعة العلم، وعبقرية الÙكر، والإØاطة بكتب التراث، والجهاد بالقلم، وقوة العارضة، وثبات الجأش، وهو ÙÙŠ الوقت Ù†Ùسه مثال ناصع على التواضع الجم، والنبل الÙياض، واللط٠الغامر مع أصØابه ومØبّيه.
ولا اعتراض على اتصا٠شاكر -رØمه الله- بعدد من هذه الأوصا٠المتميزة، ولكنّ السرد الأØادي والتبجيلي للصÙات المثالية Ùقط ÙŠÙلغي Ùرادة الإنسان الذي تÙشكّل عيوبه ووجوه القصور عنده جزءاً مهماً من كينونته الخاصة وبصمته الÙردية غير المكررة. أمّا ضجيج التهويل وصخب المبالغات Ùلا يقدّم شيئاً سوى تشويه الØقيقة الإنسانية الأعمق للكاتب، هذا بالإضاÙØ© إلى الأثر الوخيم جداً لمثل هذا التهويل التبجيلي المتواصل ÙÙŠ تقليم الØساسية النقدية عند القارئ تجاه ما تضمّه مؤلّÙات Ù…Øمود شاكر من آراء وانطباعات وانÙعالات ومواقÙ.
واقرأ مثلاً ما كتبه Ø£Øد أشهر الأتباع المتأثرين بمØمود شاكر، وهو Ù…Øمود الطناØÙŠ رØمه الله، Øيث يصÙÙ‡ ÙÙŠ مقال منشور، Ùيقول: “إن Ù…Øمود شاكر قد رÙزÙÙ‚ عقل الشاÙعي، وعبقرية الخليل، ولسان ابن Øزم، وشجاعة ابن تيمية، وبهذه الأمور الأربعة مجتمعة Øصّل من المعار٠والعلوم العربية ما لم ÙŠØصله Ø£Øد من أبناء جيلهâ€([46]).
وما كان أغنى Ù…Øمود شاكر عن هذه الإطلاقات التبجيلية ذات النكهة الشعرية، على طريقة أبي تمام: (إقدام٠عمرو٠ÙÙŠ سماØØ© ØاتمÙ…)ØŒ وعن هذا التØنيط الأداتي الذي ÙŠØوّله إلى هيكل Ùكري متعال٠عن Øقيقته الإنسانية ونتوءاته الناشزة التي هي أدلّ شيء على تميّزه، وعلى الجهد الكبير الذي ظلّ يبذله طوال Øياته، بغية الوصول إلى أكمل صورة ممكنة منه، Ùˆâ€Ù„ـمّا يكدâ€.
والغريب بقاء هذه الظاهرة (الشاكرية) وتوسÙّعها، Ùما يزال اللاØÙ‚ يتلقى عن السابق العبارات المسكوكة Ù†Ùسها، وذلك الإكبار المقارب للتقديس، وكلّ ذلك Ø§Ù„Ù…Ø¯ÙŠØ Ø§Ù„Ù…ØªØ¶Ø®Ù‘Ù… والـمÙلقى على عواهنه دون أي مراجعة أو مساءلة أو توقÙÙ‘ÙØŒ وكأنما كان Ù…Øمود شاكر Ù†Ùسه يتØدث عنهم Øين قال ÙÙŠ كتابه (أباطيل وأسمار): “ولكن هكذا زماننا: رواج الأÙØدوثة Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø¯Ø Ø£Ùˆ بالذمّ ÙŠÙتلقَّى بالتسليم المغمض العينين، ويسيطر بالوهْم على منابع الÙكر ومساربه “([47]).
وإنك لتشÙÙ‚ على هؤلاء الأتباع المنبهرين وهم يتØدثون بثقة Ù…Ùرطة عن صلابة ظاهرة كان يتقوَّى بها أستاذهم، وعن اكتساØ٠هادر يظنّون أنه صادر منه، وليس Ù…Øيطاً به، دون أن يتنبهوا إلى سر هذا الوقو٠الطللي الممتد والمكرر الذي التهَمَ عمر Ù…Øمود شاكر وهو يتذكر ÙÙŠ وجَل لا يكاد ينطÙئ لهبه (عاصÙØ© الجامعة) وما أثارتْه ÙÙŠ Ù†Ùسه من Øيرة غاشية متلدّدة، ودون أن يتساءلوا عن مغزى هذا الهجاء المرير -الذي لا يملّ شاكر من ترداده- لعصر٠يØتر٠Ùيه المÙكرون العرب تØطيم كنوزهم الثمينة، طمعاً ÙÙŠ ÙÙتات متناثر من كنوز (الآخرين).
لقد شاهد بنÙسه كي٠تØطمتْ كنوزه الأثيرة بين ناظريه، قبل أن يسعى -مشياً على الأشواك- ليجمعها، ويÙلمْلم كسورها المتناثرة، وينظمها ÙÙŠ عÙقدها كي تتلألأ من جديد، وتÙنير دربه المهجور وخطْوه المستأن٠بعد طول انقطاع.
10-الأمنية المضمَرة:
ثم ترى Ù…Øمود شاكر Ù†Ùسه وهو يكش٠لك مراراً وتكراراً وبصراØØ© تلقائية عن صورته الأصدق ÙˆØقيقته الإنسانية الأعمق Øين ÙŠÙسيل Øبراً غزيراً على امتداد مؤلÙاته ومقالاته ومقدمات تØقيقاته وهو يتعوّذ بوجل ظاهر من غائلة هذا الاستهواء الذي كاد يجرÙÙ‡ ÙÙŠ شبابه Øين كان عمره دون العشرين، وإنك لتعجب كي٠اØتÙظ ÙÙŠ داخله -على بÙعد العهد وتطاول الزمن- بسخونة تلك اللØظة الÙتيّة والدÙّوار الذي أصابه من دوّاماتها، وكأنما هو Øكم الأبد أن يظل Ù…Øمود شاكر دائماً: ذلك التلميذ العشريني الغضّ الذي Ø±Ø§Ø ÙŠØ¯Ùع قبضة طه Øسين الملتÙّة Øول عنقه كي يتنÙس !
صØÙŠØ Ø£Ù† قبضة هذا الÙتى العشريني قد اشتدت بعد ذلك، وازدادت صلابتها مع الأيام، Øتى استطاعت ببراعة مشهودة أن تÙشعر طه Øسين -ÙÙŠ المقابل- ببعض الاختناق والتضايق ÙÙŠ مناسبات متعددة، خاصة بعد التØقيق العلني على رؤوس الأشهاد الذي مارسه Ù…Øمود شاكر تجاه معلمه القديم، وما رأى أنه سطْو -آخر- متعمّد من طه Øسين على بØثه الذي نشرتْه (المقتطÙ) بعنوان: (المتنبي)ØŒ وهو البØØ« الذي تØوّل بمرور السنوات وتوالي التعقيبات إلى كتاب ضخم طويل الذيول.
ولكن يجب أن نتذكر هنا أن قبضة شاكر كانت ÙÙŠ الأساس قبضة علمية ومنهجية وأخلاقية، بينما كانت قبضة طه Øسين التي اعتصرتْ عنق شاكر قبضة Ùكرية عقدية، وامتØاناً خانقاً للضمير الديني والمعار٠المسلّمة، والأخيرة أوجع وأÙظع.
ومن اللاÙت أن Ù…Øمود شاكر كتبَ -بعد ÙˆÙاة طه Øسين بخمس سنوات، وعمر شاكر آنذاك يناهز السبعين- ثلاث مقالات مطوّلة ÙÙŠ مجلة الثقاÙØ© جعل عنوانها: (المتنبي ليتني ما عرÙتÙÙ‡)([48])ØŒ وإذا استثنيتَ شرØÙ‡ المتدرّج لمنهجه ÙÙŠ التذوق الذي ذيّل به هذه المقالات، Ùإن مجمل Øديثه الشجي المتدÙÙ‚ Ùيها كان يدور Øول شخص واØد، ولم يكن هذا الشخص هو المتنبي كما ÙŠÙÙˆØÙŠ العنوان، بل -كما هو متوقع-: طه Øسين.
كان إذن العنوان الألْيق والأدقّ تعبيراً عن هذه المقالات المتسلْسلة، وربما عن مجمل Øياة Ù…Øمود شاكر Ù†Ùسه هو: (طه Øسين ليتني ما عرÙته) !
ولو كان ممكناً أن تتØقق هذه الأمنية المضمَرة، Ùربما لن يبقى من Ù…Øمود شاكر الذي نعرÙÙ‡ الشيء الكثير. هكذا يبدو أن المعاناة النازÙØ© والصدمات الممÙضّة هي ما يصنع العقول الÙارقة، وأن لبعض الأضداد أياديَ لا تÙنسى ÙÙŠ إيقاد الجذوة التي ذوتْ داخل النÙس، بأثر الاعتياد والأÙÙ„ÙØ© والمقاربة المتواطئة بين المتواÙقين.
ج-ØªÙ„ÙˆÙŠØ Ø£Ø®ÙŠØ±:
ÙŠØسÙÙ† بنا ÙÙŠ خاتمة هذا العرض أن نشير إلى أن صيغة التÙاعل التي بÙنيتْ بها كلمة (التلاقØ) الواردة ÙÙŠ العنوان تقتضي أن التأثر والتأثير متبادل بين الطرÙين.
صØÙŠØ Ø£Ù† بعض الأمثلة التي ذكرناها مثل علاقة الغزالي بابن سينا، وعلاقة ابن رشد بالغزالي تبدو -ظاهرياً- علاقة من طر٠واØد، لأن الطر٠المتأخر ÙˆÙÙ„Ùد بعد ÙˆÙاة الطر٠المتقدم، ولكن Øتى ÙÙŠ هذه الØالة Ùإن معنى Ø§Ù„ØªÙ„Ø§Ù‚Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¨Ø§Ø¯Ù„ يظل راسخ الوجود، إذْ كي٠يمكن أن ÙŠÙقرأ تراث ابن سينا وأÙكاره، دون أن يستØضر القارئ -من غير أن يشعر Ø£Øياناً- آراء الغزالي Ùيه، وتأويله الخاص له؟ وكذلك الØال مع تراث الغزالي بعيون ابن رشد الØÙيد.
أمّا Ùيما يخص نموذجنا المØدد، Ùلا يمكن استبعاد أثر Ù…Øمود شاكر المØتمل -بالإضاÙØ© إلى مؤثرات أخرى- Ùيما يلاØظه المتابع لمسيرة طه Øسين من تراجع خجول وغير Ù…ØµØ±Ù‘Ø Ø¨Ù‡ عن بعض أطروØاته المبكرة Øول الشعر الجاهلي والثقاÙØ© العربية القديمة، وهو ما يمكن رصد دلائله ÙÙŠ مقالات (Øديث الأربعاء) التي جÙمعتْ بعد ذلك ÙÙŠ كتاب مستقل، ÙˆÙÙŠ هذه المقالات نرى طه Øسين ÙŠØلل باØتÙاء كبير قصائد متنوعة لمجموعة من الشعراء الجاهليين، مثل: لبيد، وطرÙØ©ØŒ وزهير([49])ØŒ متخطّياً تشكيكه القديم ÙÙŠ صØØ© انتساب معظم الشعر الجاهلي إلى عصره، ومتجاوزاً سؤاله المبدئي ÙÙŠ كتابه المثير للجدل: “أهناك شعر جاهلي؟â€([50]).
هذا بالإضاÙØ© إلى نبرة الإدانة الساخرة والمعاكسة التي صار ينتهجها طه Øسين تجاه الأجيال الجديدة من (المجدّدين) الذين توهّموا أن التجديد هو قتْل القديم والتنكّر له، والانسلاخ التام عن تراثهم وثقاÙتهم ولغتهم([51])ØŒ وهي الإدانة التي لم ÙŠÙت Ù…Øمود شاكر أن يسجلها ÙÙŠ Ø¥Øدى مقالاته عن طه Øسين، وأن يعيد تسجيلها ÙÙŠ مقدمة كتابه (المتنبي) ([52])ØŒ وأن يطرب ما شاء له الظÙر، لما Ùيها من Ù…Ùارقة طريÙØ© ودلالات Ù…ÙلهÙمة.
وبعد، Ùهذا ضرب من الدرس النÙسي للأÙكار ÙŠÙبرز أثرها الهائل ÙÙŠ Øياة الإنسان وتشكيل أطواره وأØواله ومآلاته، وما يصنعه ØªÙ„Ø§Ù‚Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚ÙˆÙ„ المتباينة من أقدار ومصائر تتلوّن -بتÙاوت الإرادة والوعي والمرجعية- ما بين اليقظة الممتنّة، والانكسار المباغت، والانبعاث المتجدد العنيد.
وقد رأينا -بعÙبرة التاريخ، وشهادة الواقع، وتجسÙّد النموذج- كي٠يØرّض الأضداد بعضهم بعضاً على الإبداع وتوليد الأÙكار، والبراعة ÙÙŠ عرضها والاØتجاج لها، وكي٠يكتش٠الإنسان Ù†Ùسه ويستبين طريقه من خلال نقيضه التام، أو ما يظن أنه نقيضه التام.
ومعظم الناس لا يدرك هذه الØكمة العظيمة من (لعبة الأضداد)ØŒ ومن ضرورة بقاء خصمه ومداÙعته له، وأن هذه (المداÙعة) المتأرجØØ© هي ما ÙŠÙنجيه من تغوÙّله الذاتي، ويØقق التوازن ÙÙŠ شخصيته وتوجÙّهه.
وبإدراك هذه الØكمة ربما يتمكن الإنسان من التÙرÙّغ أكثر لتأمÙّل Ù†Ùسه التي بين جنبيه، هناك: Øيث تمور الرغبات والأوهام والنوازع والأطماع، وأدواء الذات المتضخمة التي تÙجيد التنكÙّر بلباس الأنا الجمعية ورداء المناÙØØ© عن (القضية)ØŒ وإذا كان لنا ÙÙŠ نهاية هذه الرØلة الممتدة مع Ù…Øمود شاكر أن نستأنس ببعض لوازمه ÙÙŠ الكتابة، Ùقد آنَ لنا أن نلتÙت إلى صاØبه الأثير أبي العلاء المعري ليØدّثنا ببلاغته العابرة للقرون عن الضدّية الأجدر بالتوقÙّي والاØتراس: ضدّية الذات للذات:
Ù„Ùبْت٠Øول الماء Ù…ÙÙ† ظمأ٠إنَّ غَـربـي ما لـه مَــرَسÙ
Ù…Ùهـجــتـي ضÙـدٌّ ÙŠÙــØـاربـنـي أنا Ù…Ùنّي كي٠أØترÙس٠؟
([1]) مقدمة Ù…Øمود شاكر لكتاب أسرار البلاغة للجرجاني/١٧-٢٣.
([2]) جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/١١٢٦.
([3]) رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا: ٦، ÙˆÙÙŠ Øديثه المتكرر عن هذه المØنة انظر أيضاً كتابيه: قضية الشعر الجاهلي: Ù¡Ù ØŒ ١٠٣، وأباطيل وأسمار: ٢٣.
([4]) جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/١١٤٦.
([5]) مداخل إعجاز القرآن: ٨.
([6]) جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/١١٦٧.
([7]) مداخل إعجاز القرآن: ١٤، وانظر كذلك اØتجاجه المطوّل والمتسلسل لهذا الربط بين صØØ© الشعر الجاهلي وإعجاز القرآن ÙÙŠ كتابه الآخر: قضية الشعر الجاهلي: ٩٤-١٢٣.
([8]) انظر: مداخل إعجاز القرآن: ٤٢-٤٧، ١٣٠-١٣٣.
([9]) انظر: كتاب المتنبي: ١٢-١٩.
([10]) انظر: ÙÙŠ الشعر الجاهلي لطه Øسين: ١٥، ١٨.
([11]) رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا: ٨، وانظر Ùيه أيضاً: ٢٣-٢٥.
([12]) رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا: Ù¦.
([13]) جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/١١٤٧.
([14]) انظر: قضية الشعر الجاهلي: ١٠٧.
([15]) مداخل إعجاز القرآن: ١٣.
([16]) انظر: مستقبل الثقاÙØ© ÙÙŠ مصر لطه Øسين: ٢١-٣٢.
([17]) انظر: رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا: ١٥٥-١٦١، وجمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/١٠٧٨-١٠٨٨.
([18]) انظر: رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا: 151-167ØŒ وكتاب المتنبي: 20-34ØŒ ومقدمة تØقيقه لكتاب (أسرار البلاغة) للجرجاني: 17-29.
([19]) جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج١/٥١٥.
([20]) جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج١/٥٢٠.
([21]) أباطيل وأسمار: ٢٣، ٣٢، ٣٩.
([22]) جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/١١٢٩.
([23]) جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/٩٩٠.
([24]) انظر: كتاب المتنبي: ٤٠٨-٤١٠، ٤١٧، ٤٢٢-٤٢٥، ٤٣٣.
([25]) جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/1122.
([26]) انظر: جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج١/٥٤١، ٥٦٧.
([27]) انظر: كتاب المتنبي: ٧٩-١٢٢.
([28]) انظر: كتاب المتنبي: ٥٣٣-٥٧٤.
([29]) انظر: جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/١٢٥٥.
([30]) برنامج طبقات ÙØول الشعراء (مقدمة كتاب طبقات ÙØول الشعراء لابن سلام) ج1/Ù©.
([31]) برنامج طبقات ÙØول الشعراء (مقدمة كتاب طبقات ÙØول الشعراء لابن سلام) ج1/10.
([32]) المصدر السابق، ج1/١٤٨.
([33]) المصدر السابق، ج1/152.
([34]) المصدر السابق، ج1/١٧٦.
([35]) انظر: كتاب المتنبي: ١٥.
([36]) مداخل إعجاز القرآن: ١٢.
([37]) انظر: أباطيل وأسمار: ٢١.
([38]) انظر: رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا: ٨١-١٦٧.
([39]) رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا: 35.
([40]) انظر: رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا: ٥٣-٧٩.
([41]) انظر: برنامج طبقات ÙØول الشعراء (مقدمة كتاب طبقات ÙØول الشعراء لابن سلام) ج1/115-127.
([42]) انظر: رسالة ÙÙŠ الطريق إلى ثقاÙتنا: 74-75.
([43]) أباطيل وأسمار: ١٠-١١.
([44]) أباطيل وأسمار: ٤٣٥-٤٣٦.
([45]) انظر: الأغاني لأبي الÙرج الأصÙهاني ج3/185.
([46]) مجلة الأدب الإسلامي، ع16ØŒ ربيع الآخر-جمادى الأولى-جمادى الآخرى 1418هـ، ص152ØŒ وانظر ما كتبه الطناØÙŠ أيضاً من وص٠تبجيلي سابغ الذيول لمØمود شاكر ÙÙŠ كتابه: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي: 103-121.
([47]) أباطيل وأسمار/٢٦٣.
([48]) انظر: جمهرة مقالات Ù…Øمود شاكر ج٢/١٠٩٣-١١٨٩.
([49]) انظر: Øديث الأربعاء لطه Øسين ج١/٢٧-١٢٠.
([50]) ÙÙŠ الشعر الجاهلي: ١٧.
([51]) انظر: Øديث الأربعاء ج١/Ù¢Ù -٢٥.
([52]) انظر: كتاب المتنبي: ٣٠-٣٤.